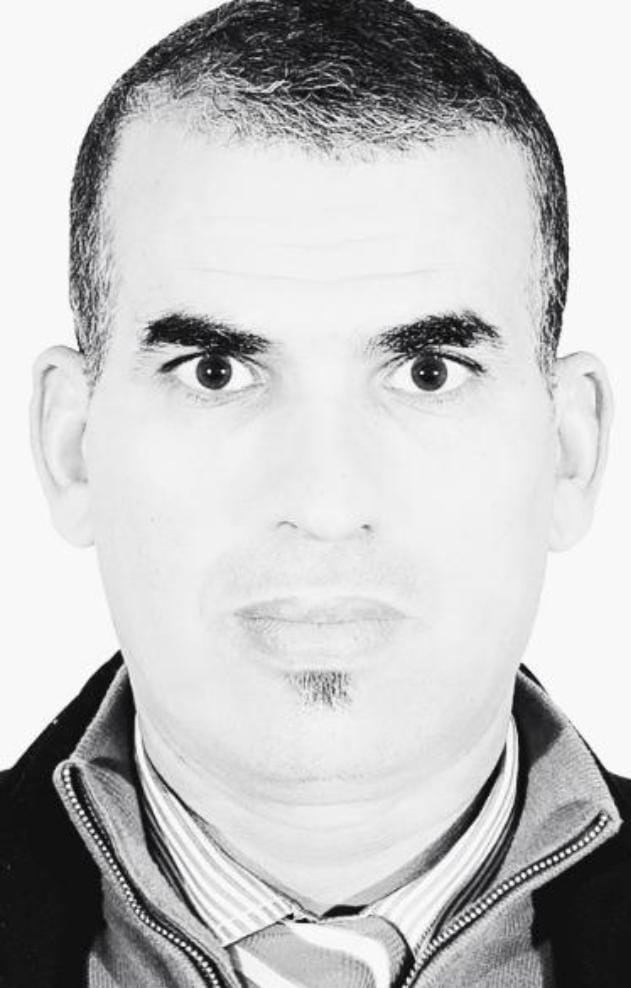سليمان محمود
يولد المغربي، وهو يقول "باسم الله"، حتى قبل أن يتعلّم نطق حروف اسمه. وما أنْ يفتح عينيْه حتى يجد جدَّه يقرأُ عليه المعوذتيْن، وقبلَه يكون أبوه قد أذَّن في أذنه الأيمن، وأقام له الصلاة في اليسرى. فعل ذلك وهو حريصٌ على أن يقوم به على وضوءٍ. وجد أيضاً جدّته ترش الملح على العتبة، وأمَّه تطعمُه بما قسَّم الله، مهما شحَّ. تقول دائما: "ولدي مربي على الحلال، بحال بَّاه اللي مكيفوتش الصلاة، حتى وهو سكران اللايعفو عليه".
يُمضِي طفولتَه وهو يقلِّد الإمام في الحركات، ويغنّي "طلع البدر علينا" في الحفلات المدرسية، قبل أن يُدرك لاحقاً أن البدر طلع بالفعل، لكن على الشيخات، لا على المدينة، وقبل أن يدرك أبوه أنه كان يصلي بها، إحدى وثلاثين عاماً، ظانا أنها من آيات القرآن.
وحين تنبُت له، في مراهقته، شعيرات فوق العانة، ويتم رفض مصاحبة أمه له إلى الحمام، خوفاً على الأثداء المتدلية، وينبت معها فضول ميتافيزيقيٌّ عجيب: من هو؟ لماذا هو هنا؟ ولماذا "تتكرفس" عليه سعاد بنت الجيران؟ يكتشف أن الله لا يجيبه، لكن الإنترنت يجيبه، فيصير نصف فيلسوف، ونصف شارب، تماماً كأبيه، ونصف ثائر، متعلق بصورة تشي غيفارا، بحب مراهق، وهو يحمل سطل حريرة، ويرتدي كوفيةً، ويزدرد الشباكية، ويبدأ إفطاره بتمرات مستوردة من إسرائيل.
يحصل على شهادة البكالوريا، فيلتحق بالجامعة. وهناك يضعف نظره من مخالطة كتب الفلسفة، والفكر الثوري، فيصير مول النظارات الذي يناقش وجود الله في كل مجمع ومقهى، على براد شايٍّ يطيل الجلوس أمامه منعنعاً بالجدال، جاهرا بمواقفه الوجودية في البوفيت، متباهياً بأفكاره المتحررة أمام الطالبات، لعله يظفر ولو بقبلة من إحداهن. وينتهي به الأمر دائماً في غرفة باردة من الفقر، يكتريها مع خمسة من الطلاب، يكادون لا يجدون عشاءهم.
يجلس على طبسيل اللوبيا، بكثير من الملح، وقليل من الدسم، يناقش أصل الأخلاق، وهو يرتشف من زجاجة بلاستيكية مشبوهة، ويسمي ذلك “مساءَلَة الكون والوجود”، بعقل نقدي حر.
يخرج من الجامعة بلا وظيفة، لكن بدفتر أسود ملئ بالقصائد العشوائية، وكثير من الشعارات المتهالكة، وبعض الوصفات القديمة عن العيش الكريم، والحرية. يعمل في شيء لا يحبّه، ويعيش مع شيء لا يفهمه.
وبعد سنوات، يجد نفسه فجأة في الأربعين، وحينها يبدأ ظهره يؤلمه، وركبته تصدر صوتاً غريباً، كبابِ فرَّانٍ صدئ، حين يصعد السلالم إلى سكنه الاقتصادي الذي يلتهم وحدته. يشعر حينها أن شيئاً ما ينقصه، وربما ذلك الشيء هو الله، أو الطمأنينة، أو ربما مجرد أصدقاء لا يتحدثون عن العقار والغلاء والتقاعد، ولا يذكرونه بالشيخوخة، فيبحث عن شلة في المؤسسات الاجتماعية. يدخل المسجدَ متسللاً بخفة وهدوء، ويحرص ألا يثير الضجيج بعقله الجامعي.
يجلس حذو الحائط، ويهمس مع رجلٍ أصلعَ حول حكم الضامة في الإسلام. يبدأ في قراءة الورد الصباحي، ويتعلّم اسم الإمام النووي، ويحفظ بعض المتون، وأبياتاً من البردة، ليرددها في حفلات الزفاف والجنائز، ويقول لصاحبه الذي ما تزال أفكار الفلاسفة تلعب بعقله المتحمس: "كنت بحالكم، ملحد، ولكن دبا عفا الله".
هكذا يُتمّ المغربي دورته التي يبدأها حين يولد مسلماً بالقرار الجماعي، ثم يضيع في زوابع الحياة، ويتمرّد قليلاً، ويشرب كثيراً، ويلف لفافات حشيش كثيرة، ويتفلسف بما يكفي، ليُعجب فتاةً في فيسبوك، ثم يعود ليركع بخشوع. لا يفعل ذلك لأنه خائف من النار، فلا شيء يخيفه سوى أن يشعر بالوحدة القاتلة، فيختار العودة للطمأنينة الجماعية؛ فتنتهي قصته بربط جلابيّته، وحمل سبحته، ويجلس على كرسي من قشّ، حذو الجامع، يراقب شباباً يمشون بحماسة كالتي كان يمشي بها، ذات زمان، حين كان يعتقد أنه قادر على تغيير العالم. لكنه الآن أدرك أن العالم لن يتغيّر، فهو ثابت، ولا يحصل شيء سوى إعادةِ تدويره، مثل القناني الفارغة، وكأننا نلد الماضي.
|
|