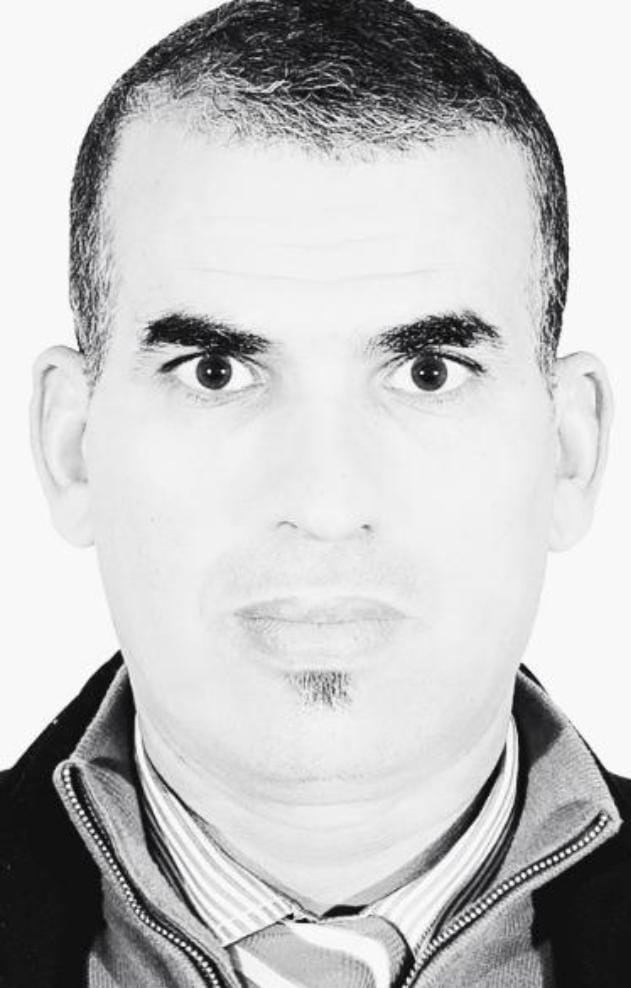محمد الدريسي - الرشيدية / جديد انفو
أثارت قرارات إعفاء مجموعة من المديرين الإقليميين بقطاع التعليم المدرسي نقاشا حول الدواعي والمبررات وعلاقتها بالتوقيت والسياق، حيث عبر العديد من الفاعلين والهيئات عن استغرابهم لاتخاذ تلك القرارات في حق مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة والجدية والتفاني في خدمة المنظومة، وفي المقابل أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلاغا في الموضوع يوم 12 مارس 2025، أوضحت فيه أن تلك العملية تأتي تفعيلا لنتائج "عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري" للمديرين الإقليميين، وقدرتهم على " المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه"، وأنها تمت في " إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".
يبدو جليا إذن، أن الوزارة اتجهت نحو "مفهوم المسؤولية التدبيرية" باعتباره وجها من أوجه ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وهي مناسبة للتساؤل عن مدى تفعيل المسؤولية التدبيرية في الإدارة المغربية، وتسليط الضوء على مقومات وشروط تفعيل هذا النوع من المسؤولية.
إن طبيعة المسؤولية المتناولة في هذا السياق تعد مفهوما أوسع وأشمل من المسؤولية الإدارية التي تعتمد على مراقبة الشرعية، أي مراقبة التسيير الإداري ومدى مطابقته للمساطر والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ ذلك أن المسؤولية التدبيرية تتجاوز هذا الإطار إلى تحمل مسؤولية نتائج التدبير ضمن مجال الاختصاصات والمهام المنوطة بالمسؤول الإداري، فهي مسؤولية تقوم على الجمع بين النتائج المرجوة والوسائل والاعتمادات المالية، وكذا حرية توظيف هذه الوسائل (هامش التصرف).
ويستمد مفهوم المسؤولية التدبيرية مرجعياته من المقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتلك المؤطرة للمرافق العمومية وتدبير المالية العمومية.
أولا: شروط تفعيل المسؤولية التدبيرية
إن تفعيل المسؤولية التدبيرية يتطلب توفر مجموعة من المقومات أو الشروط الضرورية، منها ما هو تنظيمي ومنها ما يرتبط بمناهج التدبير الحديث وآليات التقييم، ويمكن تلخيصها كالآتي:
أــــ شروط تنظيمية
تكتسي الجوانب التنظيمية أهمية كبيرة في تفعيل المسؤولية التدبيرية، باعتبار التنظيم هو القاعدة والمنطلق لتوزيع الأدوار والمهام، فالحديث عن المسؤولية التدبيرية يتطلب توافر مجموعة من المبادئ، ينبغي أخذها بعين الاعتبار في الهيكلة الإدارية، وهي[1]:
* تحديد أهداف كل وحدة إدارية
* تحديد أنواع النشاطات في الوحدة الإدارية والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها
* تحديد العمليات المطلوبة لإنجاز كل نشاط في الوحدة الإدارية، والتحديد الواضح لوظيفة كل مركز مسؤولية ضمنها
* توزيع السلطة بشكل يتناسب مع مقدار المسؤولية في كل مركز
*لتحديد الواضح للسلطة الممنوحة لكل فرد في المستويات الإدارية المختلفة والمسؤولية المطلوبة منه، مع تركيز السلطة في أيدي أفراد ذوي كفاءة وخبرة.
هذه المبادئ تتطلب توفر مناخ مؤسساتي (بيئة عمل) مناسبة لكي تعطي ثمارها في تفعيل المسؤولية التدبيرية.، مناخ ينبني على تعزيز الاستقلالية والتشاركية وحفز المبادرة والابداع وترسيخ ثقافة الشفافية والديمقراطية؛ ذلك أن البيروقراطية الإدارية القوية تعيق نجاعة التدبير والأداء في المرافق العمومية وتحول دون تفعيل حقيقي للمسؤولية التدبيرية.
ب ـ تحديث مناهج التدبير
يروم التدبير العمومي الحديث "تعويض العقلانية القانونية التي يرتكز عليها القطاع العام بعقلانية تدبيرية تشكل جوهر عمل القطاع الخاص"[2]، ومن أهم مميزات التدبير العمومي الحديث: فصل اتخاذ القرار الاستراتيجي الذي يعود للسلطة السياسية عن التدبير العملياتي الذي تضطلع به الإدارة؛ وتوجيه الأنشطة الإدارية وتخصيص الموارد تبعا للمخرجات والخدمات المفروض تقديمها، عوض أن يتم ذلك وفقا للقواعد والمساطر[3].
وفي هذا الإطار، يعتبر التدبير المرتكز على النتائج (GAR) من الأساليب التدبيرية الحديثة نسبيا بالنسبة للإدارة العمومية المغربية، فهو استراتيجية تسعى من خلالها الإدارة لأن تكون أنشطتها وأعمالها وكذا تدخلاتها وخدماتها تساهم في تحقيق الأهداف المتوخاة والتوصل إلى النتائج المرجوة من المرافق العمومية.
ويعتبر التدبير المرتكز على النتائج مدخلا ضروريا لتفعيل المسؤولية التدبيرية، حيث تشكل النتائج المتعاقد بشأنها مرجعا أساسيا لتقويم المسؤولية التدبيرية للمسؤولين الإداريين؛ غير أن إرساء دعائم هذه المسؤولية لن يكون ناجحا إلا في بيئة عمل حاملة لثقافة التقويم بأبعاده الذاتية والمؤسساتية؛ وفي المقابل كلما تم اعتماد "نجاعة الأداء " انعكس ذلك إيجابا على تفعيل تلك المسؤولية؛ في أفق جعل نجاعة التدبير والأداء العمود الفقري لمسؤوليات المدبرين العموميين، مع ما يتطلب ذلك من تخفيف للمراقبة القبلية وتوسيع لهوامش المبادرة والإبداع والاستقلالية في اتخاذ القرار.
ثانيا ـ آليات التقويم والمحاسبة في ضوء المسؤولية التدبيرية
يتطلب تفعيل المسؤولية التدبيرية تطوير آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة لكي تمتد إلى الجوانب المرتبطة بأداء المسؤول الإداري ومردودية البنية التي يشرف عليها، وألا تقتصر المحاسبة على الجوانب الإدارية والمسطرية فقط. ذلك أن أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة يتجلى من الناحية التدبيرية في "الالتزام بالتنفيذ الصحيح والملائم للسياسات العمومية، ومن خلال التوضيح المعقول والمقبول لتحمل المسؤولية نحو نتائج الأعمال، مما يعني أن تكون المسؤوليات واضحة ومحددة كعقد متفق عليه يحتوي على معايير محددة، فوجود محاسبة عقب الأعمال التي يقوم بها المسؤول يدعم تنفيذ السياسات بشكل فعال وحسب ما هو منظم له في الهيكل التنظيمي" [4] ؛ وهكذا تصبح محاسبة المسؤول جزءا لا يتجزأ من نظام تقييم الأداء، الذي يتغيا تحقيق الفعالية والنجاعة عند استخدام الموارد؛ وذلك عبر "استخدام المنطق وأساليب التقييم الموضوعية للحكم على الإنجازات المحصلة بعد تنفيذ المشروعات والأنشطة المختلفة" [5].
ويفيد ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهذا المعنى، في تطوير أداء المسؤولين والموظفين عن طريق معرفة نقط القوة ونقط الضعف لديهم وتقديم المشورة المتعلقة بتطوير هذا الأداء، وزيادة دافعيتهم للعمل، والتخطيط المستقبلي للموارد البشرية من خلال وضع المسؤول الإداري المستحق وذي الكفاءة في المكان المناسب[6]؛ ومن خلال اعتماد نظام تحفيزي يربط الامتيازات والتحفيزات بالمردودية.
ولا شك أن تفعيل المسؤولية التدبيرية يستلزم أخذ مقتضياتها ومقوماتها منذ اللحظة الأولى لسيرورة التعيين والتكليف بمناصب المسؤولية، التي تعتبر لحظة تعاقدية بامتياز وفق هذه المقاربة، كما أن مساطر التحفيز والترقية والتأديب ينبغي أن تدمج أبعاد المسؤولية التدبيرية بالشكل الذي يتجاوز القواعد التقليدية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
إن تفعيل المسؤولية التدبيرية يقتضي وجود ممارسة فعلية للتقييم والمساءلة، من خلال تقديم حساب "الأداء" بشكل منتظم، وبالتالي دعوة كل مسؤول لتقديم حصيلة فعلية لعمله بشكل دوري، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، لتقدير مساهمته في أداء الأعمال والخدمات التي هو مسؤول عنها.
ولعل الواقع يظهر أن هناك الكثير من المقاومة في المحاولات التي ترمي إلى اعتماد التقييم الموضوعي للنتائج؛ فالمنظومة الإدارية والسياسية غير قادرة في كثير من الأحيان على ممارسة أدنى قدر من السيطرة على نجاعة الخدمات العامة والنتائج الفعلية للسياسات العمومية التي يتم تنفيذها، حيث يتم التركيز والاستفسار عن المخرجات، ولكن نادرا ما يتم ربط العلاقة بين التكاليف والمخرجات، أما في بناء وتحليل المعلومات فيتم الاعتماد في جانب كبير منها على نفس الأشخاص الذين يستهدفه التقييم، خصوصا في حالات غياب الخبرة لدى القائمين بالمراقبة أو التقييم. هذا بالإضافة إلى أن الإحصاءات المتعلقة بالمردودية، غالبا ما تفتقر إلى الموثوقية والتوحيد.
ومن جهة أخرى، فمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا ينفصل عن بعد سياسي يلقي بظلاله على الموضوع[7]، حيث غالبا ما تتسع الفجوة بين تأثير الخطاب السياسي والإكراهات التدبيرية، مما يضع المدبرين العموميين أمام الاختيار بين العصيان أو الانقياد في ظل الغموض. فالبرامج الحكومية أو عقود التدبير أو البرامج التنموية الترابية تزخر بكثير من الطموحات والتمنيات، والكل يعلم أن تناولها يتم فقط لإرضاء هذا الطرف أو ذاك من الشركاء أو أصحاب المصلحة، وأن تلك الاتفاقيات والبرامج ستتغير حسب السياقات والظروف.
إن إرساء المسؤولية التدبير يستلزم تضييق مساحة الشك حول الأهداف الموكلة للبنيات الإدارية. وينبغي ألا تفقد تلك الأهداف قيمتها الملزمة، وأن تعاش باعتبارها ضرورات للعمل وليس نوايا عامة.
من خلال من سبق، يمكننا المجازفة بالقول أن الممارسة الإدارية والسياسية ببلادنا لا زالت بعيدة كل البعد عن تجسيد مقومات وشروط تفعيل المسؤولية التدبيرية، وأن هذا المفهوم وإن استعمل أحيانا لتبرير قرارات إدارية ما، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مبررا للتغطية عن أسباب وحيثيات لا علاقة لها بتقييم الأداء والمردودية، أو لتحقيق مآرب وأهداف غير معلنة.
إن تفعيل المسؤولية التدبيرية لا يستقيم في ظل مناخ سياسي وإداري متردد في تفعيل شروط المردودية في تقييم الأداء؛ مناخ يعلن بسهولة أن الكفاءة أمر مرغوب ومطلوب، لكنه يتراجع عن جعله ضروريا في تعاطيه العملي مع مناصب المسؤولية تعيينا وتدبيرا وتقييما.
صحيح أن الخطاب السياسي والإداري يعج بمضامين ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن الفارق الكبير بين الخطاب والممارسة واقع لا يرتفع، فالأمن الوظيفي بالإدارات العمومية شبه مطلق، ونادرا جدا ما نجد مسؤولا إداريا يعتمد فعليا معايير الأداء والمردودية في تقييمه للموظفين وترقيتهم، وذلك ربما تفاديا للدخول في متاهات وإجراءات لا متناهية تجعل منه نشازا في الوضع العام؛ كما أن التعيين في مناصب المسؤولية غالبا ما يحتكم إلى معايير وعوامل خارج نطاق الكفاءة والخبرة المكتسبة في المجال أو المهمة المعنية. إن هذا الوضع يدفع المسؤولين الأكثر شجاعة وجرأة إلى الاستسلام، ويرسخ مناخ الإفلات من العقاب، وغياب معنى الجدية والمبادرة والإبداع في العمل التدبيري، مناخ تتآكل فيه أخلاقيات وقيم العمل وبالتالي تتراجع فيه المردودية والنجاعة وتضمحل فيه المسؤولية التدبيرية لصالح المسؤولية القانونية والإدارية. وقد يصل الأمر إلى حد التناقض عندما يعاقب ــ بشكل أو بآخر ـــ مسؤول معين نتيجة جديته ومبادرته ونزاهته، فالأكيد أنه ليس بقص أجنحة الموظفين الأفضل، أو خنقهم، أو معاقبتهم أحيانا، سوف نبني المستقبل الإداري والمجتمعي المأمول.
[1] هاني يحيى الجعدبي، ربط المسؤولية بالمحاسبة وآليات التفعيل، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2024، ص: 64 ـ 65
[2] محمد اشنيفخ، الوظيفة العمومية المغربية وسؤال تحديث مقاربة تدبير الموارد البشرية، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2020، ص334
[3] نفسه، ص: 338
[4] هاني يحيى الجعدبي، مرجع سابق، ص: 49
[5] نفسه، ص: 53
[6] نفسه، ص: 54
[7] Alain Eraly et Jean Hindriks. LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ DANS LA GESTION PUBLIQUE. Reflets et Perspectives, XLVI, 2007/1, p. p : 198 ;199


.jpg)